
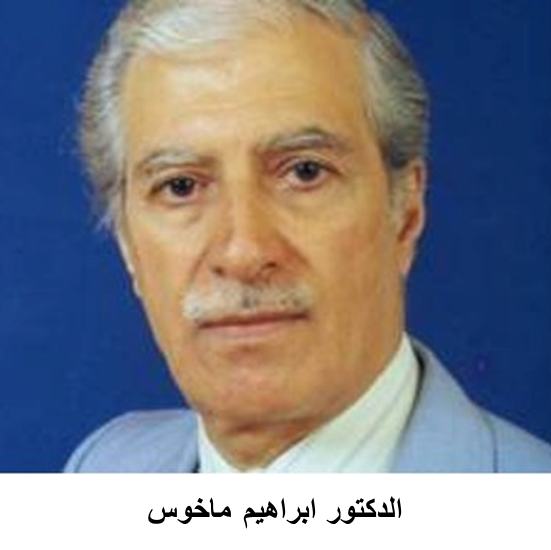
*بعض الاستنتاجات العامة*
[تنويه: كتب الدكتور ابراهيم ماخوس مذكراته هذه قبل عام 2010، ولكنها لم تنشر قبل الآن- ابراهيم معروف]
وفي ختام هذا الفصل، “الحزب والانقلابات العسكرية في المرحلة السابقة للوحدة”، نود التأكيد على بعض الاستنتاجات الهامة:
1– البرجوازية والانقلابات العسكرية في العالم الثالث:
“إن البرجوازية في العالم الثالث لا تقبل بالعملية الديمقراطية الحقيقية- حتى الليبرالية- وعندما تفلس- بحكم تخلفها وانحطاطها وتبعيتها للخارج – تلجأ للجيش ليقوم بالانقلاب الرجعي، ويستخدم كمطرقة لسحق الحركة الشعبية، وتنفيذ مصالح الاستعمار والرجعية.. فقد كان النضال الديمقراطي ينضج وعي الجماهير، ويزج –تدريجياً- بأقسامها الواسعة في العمل السياسي والوطني العام، أما الانقلابات العسكرية: سواء المشبوه منها والذي لجأت إليه القوى المعادية (الاستعمار والرجعية) لاستباق وإجهاض الحركة الشعبية وحزبها، أو تلك الوطنية منها، فلقد كانت في محصلتها العامة ضد الديمقراطية وعلى حسابها. ورغم التحولات والانجازات التقدمية التي تمت: اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وعن طريق تلك الانقلابات الوطنية في سورية ومصر والعراق وغيرها من الأقطار العربية.. ففي النتيجة النهائية – التي لم تكن مضمونة- بل مهددة وسلبية خاصة فيما يتعلق بتقليص الحركة الشعبية والضامنة الحقيقية لأي إنجاز، لأن تلك الانجازات الهامة جداً التي تمت بقرارات فوقية، قد تم التراجع عن معظمها، وتشويه بعضها الآخر، واستغلاله (كبقرة حلوب) خاصة، من قبل الأجنحة اليمينية المتبرجزة المرتدة، التي أفرزتها تلك الانقلابات، في غياب الحركة الشعبية المنظمة المستقلة، ومشاركتها الفعالة التي ضمرت خلال غياب الديمقراطية”. وهذا لا يعني أن الأنظمة الديمقراطية -غير المحصنة شعبياً بشكل كاف، يمكن أن تحول دون قيام الردة- كما سنرى لاحقا.
وإذا ذهبنا بهذا الاستنتاج الخطير، إلى مداه الأبعد، لابد أن نذكر بالظاهرة (النازية والفاشية) المعروفة، في أوروبا الغربية بالذات (مركز الديمقراطية الليبرالية) العزيزة على قلوب الغرب. ولجوء البرجوازية لاستخدامها في سحق الحركة الشيوعية والعمالية الناهضة في ألمانيا وإيطاليا-إذ ذاك- والتي كانت تهدد الرأسمالية فيهما ثم تفطنها، لمخاطر تلك الوسيلة المرعبة- في عقر دارها- بعد أن ارتدت إلى نحورها بإضرام الحرب العالمية الثانية المدمرة، ومن ثم العودة إلى الحرص على ديمقراطيتها الليبرالية المطبقة في بلدانها، (مع الاستفادة من تجربة البلدان الاشتراكية، في تقديم بعض المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة، بغية تمييع وتخفيف الصراع الطبقي عندها)، والتحول إلى (تصدير) الفاشية والديكتاتورية إلى بلدان العالم الثالث- وحيثما توجد مصالحها- لقمع الجماهير وقواها الحية، وحماية تلك المصالح غير المشروعة، والنهب التاريخي لتلك الشعوب.
ولقد كانت الدول الغربية الرأسمالية، ولا زالت، رغم الضجيج الحالي المتعالي- بعد انهيار الإتحاد السوفيتي على الخصوص- بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، تستنجد بها كذباً ونفاقاً للتدخل في الشؤون الداخلية لمن تبقى من الدول الاشتراكية، وكذلك للضغط بها على الدول الأخرى، التي تريد ترويضها واحتوائها، أو حماية أنظمتها المهددة الموالية لها، (لممارستها) في حدود التنفيس، وكصمام أمان لتخفيف الاحتقان الشعبي، وتفادي احتمالات الإنفجار، وخداع وتضليل الجماهير في تلك البلدان، التي تشهد غلياناً اجتماعياً، وحركاتٍ وطنيةٍ معارضة، وذلك ضمن هوامش محددة ومحسوبة بدقة، وفقاً لوضع كل بلد، بما يضمن استمرارية الأنظمة التابعة ذاتها. بينما تستمر في معظم المناطق الأخرى، حيث مصالحها الحيوية الكثيفة، كشبه الجزيرة العربية والخليج العربي مثلاً، في حماية أعتى الأنظمة الرجعية وأشدها استبداداً في العالم. الأمر الذي يجسّد نفاق الإمبريالية، ويحدد (مكاييلها) وأساليبها (الميكافيلية) المتبذلة، والوحشية، ويؤكد الانعدام المطلق للضمير والقيم الإنسانية، وعدم الالتزام بالقواعد والأسس والقوانين الدولية المعتمدة عالمياً، التي ساهمت هي بالذات في وضعها بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي تجوّف (حضارتها) المادية المزدهرة، بالتقدم العلمي والتقني المذهل، والمتناقضة مع القزامة الروحية، والهزال الأخلاقي المريع، وكل ما يميز إنسانية الإنسان، وخطر نهجها الرأسمالي السرطاني المسعور في التعامل مع الشعوب – الذي تحولت معه إلى مسخ أسطوري مخيف- على مصير العالم بأسره.
2- تطور أساليب الانقلابات العسكرية:
يمكن القول أن العقيد أديب الشيشكلي قد دشن (مدرسة انقلابية) جديدة، تقوم أساساً على ما يلي:
– التدرج في مراحل استلام السلطة الكلية، وعدم ظهور (بطل الانقلاب) الحقيقي مباشرة على المسرح، واستلامه السلطة علنا، إلا بعد أن تستتب الأمور نهائياً، وبقائه في الظل يحرك الأحداث من وراء الستار، كما فعل هو في (انقلابه الأول) من خلال موقعه (كمساعد) لرئيس أركان الجيش.
– تشكيل (تنظيم سياسي) واجهي مصطنع وحيد (حركة التحرير العربي)، كأداة لخدمة السلطة، تقوم على تجميع المرتزقة والانتهازيين (كمغناطيس الحذّاء، الذي يلتقط به المسامير المعوجة المتساقطة خلال العمل)، مع حل الأحزاب السياسية القائمة، وقمع أية معارضة بمنتهى العنف.
– استخدام (لعبة) الاستفتاء الشعبي، على (دستوره الرئاسي المفصل على قده)، وانتخاب (بطل الانقلاب) كمرشح وحيد متجدد، بدون حدود، بنسب عالية جدا بين (90-100)% .
– انتخاب (مجلس نواب) مزيف، بإشراف أجهزة السلطة، فاز فيه كل مرشحي (حركة التحرير العربي) بالتزكية، مع إضافة عدد محدد ومحسوب لبعض التجمعات الانتهازية الملحقة بالسلطة (بصفة مستقلة) لتزيين (الديكور الديمقراطي).
– وكل ذلك بهدف تشكيل واجهات وهياكل مضللة ومفرغة من أي مضمون ديمقراطي أو سلطة حقيقية على الإطلاق، لستر الديكتاتورية العسكرية القائمة، (وتقنين) الحكم الفردي المطلق.
“كما أن تكريس (القوانين القراقوشية) المعادية للديمقراطية والمقيدة، لحريات المواطنين قد أصبحت (سنة انقلابية)، فكلما جاء انقلاب جديد كرّسها، وأضاف إليها قوانين تعسفية جديدة، تستنزف حيوية الشعب، وتعزز الهيمنة الامبريالية الصهيونية”.
ولقد التقطت الانقلابات العسكرية المتوالية، حتى الآن، أساليب هذه (المدرسة الشيشكلية الأولية)، وتعلمت منها وحوّلتها إلى جامعة، واستخدمتها، وواصلت (تطويرها)!!! وخاصة بعد صعود البرجوازية الصغيرة واستلامها السلطة عن طريق هذه الانقلابات “حتى أن بعض الأنظمة الديكتاتورية العسكرية الحالية، في المنطقة” قد وصلت بها إلى (قمتها) سواء من حيث (التدرج) أو (النهج العام) المتبع في فن تشكيل الواجهات والهياكل (البيروقراطية والمخابراتية) المفرغة من أي مضمون ديمقراطي حقيقي مثال (مجالس شعب + مجالس محلية + حكومية بأكثرية من “حزب السلطة” + ديكور محدد من بعض الأحزاب الانتهازية التافهة المرتبطة بالسلطة+ نظام رئاسي مطلق مع رئيس جمهورية منتخب مباشرة من نسبة 99،99% ( !!!) كمرشح واحد وحيد طبعاً، ومتجدد بغير زمن محدود، تراوح حتى الآن من ربع قرن إلى ثلث قرن وهو مستمر عملياً، مدى الحياة، وبتوجهات (عائلية وراثية ملكية) غالباً، وأكثر من ذلك أحزاب (عقائدية) و(جبهات وطنية تقدمية)، تضم شيوعيين أيضا، حسب متطلبات المرحلة، أو تنظيمات (جماهيرية) (مبتكرة) لم يعرف لها مثيل من قبل..الخ. الخ.
ووراء ذلك كله، يكمن أعتى أنواع الحكم الفردي المطلق، واحتكار السلطة وحياة الوطن بأسره، والاستبداد والفساد والإفساد، وتمزيق النسيج الاجتماعي الوطني، وإقصاء وتشريد (وتغريب) مئات الآلاف من المواطنين، داخل الوطن وفي الخارج، بشكل يصبح معه عهد الشيشكلي الأسود قزماً جنينياً لا أكثر، و(مدرسته) المذكورة مجرد (دار حضانة) فقط.
ولم يعد المواطن العربي يفرق -في الحقيقة والواقع- وبغض النظر عن التسميات واللافتات (الرسمية) بين (الجمهوريات) الديكتاتورية “الجمهولكية” والملكيات الرجعية التقليدية الوراثية!!!.
3 – الموقف من الانقلابات العسكرية.. وكيف يجب أن يكون:
قد يقول البعض: إنكم تناقشون موقف الحزب من تلك الانقلابات القديمة على ضوء وعيكم الراهن، ويتساءلون: كيف كان على قيادة الحزب أن تتصرف أمام تلك الانقلابات؟ في ظروفها التاريخية المحددة، وأوضاع الحزب والبلد الواقعية، الخاصة والعامة، والأحوال العربية والدولة المحيطة ؟؟!
والجواب على ذلك أنه كان يجب على القيادة أن تتريث لدراسة الموقف جيداً، ولا تبادر فوراً إلى تأييد أي انقلاب إثر حدوثه، وخاصة ذلك الذي تعرف القائمين به مسبقاً بأنهم سيئون ومشبوهون، أو أولئك الذين لا تعرف حقيقتهم بالضبط.
وأن تترقب، وتنتظر -على الأقل- لتتحقق من هويتهم ونواياهم، ولترى برامجهم وخططهم (المعلنة)، ومدى التزامهم في ممارساتهم العملية، ومواقفهم من الديمقراطية والحريات العامة على الخصوص، ومن المشاريع الاستعمارية المطروحة إذ ذاك. وأن تطرح موقف الحزب من المطالب الشعبية في تلك الفترة، ومن تلك المشاريع الأجنبية المعادية المعروفة ( كما فعلت لاحقاً بحق) وتعلن أن موقف الحزب من الانقلاب يتحدد على ضوء ذلك، وعلى مدى استجابته له وتجسيده واقعياً، فلا تعطيه أية شرعية مجانية مسبقة – كما كان يحدث فعلاً- حيث “يتمسكن حتى يتمكن” حسب المثل الشعبي!!
وهكذا، مع ضرورة إعلان الموقف المبدئي فوراً برفض أي حكم عسكري ديكتاتوري – مهما كان- والتمسك بالنظام الديمقراطي فقط، والمبادرة لمحاولة إقامة (جبهة وطنية ديمقراطية عريضة) تتخذ الموقف ذاته. وطلب تشكيل حكومة وطنية ائتلافية تشرف على انتخابات نيابية نزيهة- ودستور ديمقراطي..”، بحيث يجد (الانقلاب) نفسه معزولاً ومحاصراً من الجميع، فإما أن يذعن أو يكشف عاجلاً، ويسهل إسقاطه بسرعة في مواجهة الشعب وقواه الحية…
ثم إذا (فسّرنا) التسرع في تأييد الانقلاب الأول الذي قام به “حسني الزعيم” (رغم أنه شخص سيئ معروف)، كما ذكرنا سابقاً، برد الفعل العفوي الانفعالي، من قمع وفساد النظام الإقطاعي البرجوازي الرجعي القائم، وبانعدام التجربة السابقة في مجال الانقلابات، وقصور الوعي السياسي عامة.. الخ..الخ. فكيف يمكن أن نفسر- ناهيكم أن (نبرّر) – تكرار ذلك الخطأ، في الموقف من الانقلابيين اللاحقين (الحناوي والشيشكلي)؟؟ وعدم استيعاب وتمثل كل ذلك حتى انعقاد “المؤتمر القومي الحزبي المصغر السري” في تشرين الأول (أكتوبر) 1953 في مدينة حمص، إبان عهد الشيشكلي (في غياب الأساتذة الثلاثة في روما)، واتخاذه ذلك القرار الهام، الرافض للديكتاتورية العسكرية، وأية نظام ديكتاتوري آخر، وإدانته للانقلابات وتأكيد تجربتها الفاشلة (كما ذكرنا سابقا، في مجال: انجازات الكوادر الحزبية المتميزة)، والإصرار على النظام الديمقراطي.
4- مسألة استلام السلطة:
إن تردد الحزب إزاء هذه المسألة، وتخوّفه من الإقدام على استلام السلطة، بعد إسقاط نظام الشيشكلي الديكتاتوري، وحسب تحليلات الأستاذ أكرم الحوراني -على الخصوص- لم يكن بلا أساس: لا من الناحية النظرية المجردة، أو الواقعية، وذلك أمام وطأة الشعور بثقل المسؤولية الوطنية والقومية، في مواجهة مخططات الرجعية الداخلية والعربية والامبريالية والصهيونية المحيطة. وقناعة القيادة أن الحزب لم يكن مهيئاً بعد لتحمل مسؤولية السلطة (انظر حديث الأستاذ الحوراني مع مصطفى دندشلي في عام 1969 ثم في عام 1970(1) .
ورغم استبعادنا لإمكانية “الهجوم العراقي- الأمريكي- أو التركي” المباشر على سورية في تلك الظروف، إلاّ أن مخاطر التدخل الامبريالي- الصهيوني – الرجعي كانت، ولا تزال، قائمة حتى الآن، وربما أكثر من السابق، وسوف تستمر إلى أمد غير قصير، ضد أي تغيير ديمقراطي جذري في الوطن العربي، يمكن أن يقدم على مس (المحرمات): [[(إسرائيل)، ورفض التسوية التصفوية الحالية + البترول واستثماره وطنياً لصالح الأمة + التنمية الوطنية القومية الحديثة المستقلة + الوحدة العربية]].
ومن استعراضنا لتجارب وطننا العربي السابقة، منذ محاولات محمد علي، والشريف حسين وتجاربه اللاحقة المعاصرة، نلاحظ أشكالاً من التدخل العسكري الفوري المباشر الواضح أو المقنع أو المتريث، واستخدام أساليب تآمرية أخرى -غير مباشرة- تبعا لكل حالة، ولظروفها الخاصة، وبعد اصطناع (إسرائيل) في قلب المنطقة على الخصوص.
فقد تم إثر ثورة 14 تموز 1958 في العراق إنزال وقائي تحذيري مباشر، لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت (بالتعاون مع الرئيس شمعون)، وقوات المظليين الانجليز الحمر في عمان (بالتعاون مع الملك حسين) وقيل وقتها بطلب مباشر منهما، مع التهديد بالتدخل في العراق بالذات إذا انضم إلى “الجمهورية العربية المتحدة”، أو تعرض لمصالح انجلترا والشركات الامبريالية الأخرى البترولية في العراق ( كما سنرى في حينه).
وجرى التدخل المسلح المعروف – والمتعدد الجوانب- ضد ثورة سبتمبر 1962 الجمهورية في اليمن الشمالي- الذي هبّ الرئيس عبد الناصر لنجدتها بشهامة قومية بالغة الجرأة، وكذلك نظام البعث التقدمي في سورية، الذي أكمل ذلك الدور، بعد اضطرار مصر لسحب قواتها إثر عدوان حريزان 1967، والتي توجت بالنصر، دون أن ننسى العدوان الثلاثي: الانجليزي- الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام 1956، بعد إقدام الرئيس عبد الناصر على تأميم قناة السويس، واندحار ذاك العدوان أيضاً، وإطلاقه موجة جديدة هائلة من النهوض القومي في الوطن العربي بأسره.
ومن جهة ثانية، لم تتدخل القوات البريطانية التي كانت مرابطة في منطقة قناة السويس في مصر إبان ثورة 23 يوليو 1952، التي أسقطت النظام الملكي في مصر.
وكذلك لم يحدث تدخل أجنبي مباشر بعد حركة 8 شباط (14 رمضان 1963 في العراق ضد نظام عبد الكريم قاسم، ولا بعد حركة 8 آذار 1963 في سورية ضد نظام الانفصال، مع أخذ كل الظروف العربية والدولية المتعاونة، بعين الاعتبار طبعاً، وذلك حتى عدوان حزيران 1967 الصهيوني الامبريالي المتواصل، الذي (صفى) الحسابات، مرة واحدة مع حركة التحرر العربي الثورية، وما زال مستمراً، بكل مفاعلاته التصفوية التي أصبحت واضحة للجميع، بعد رحيل الرئيس عبد الناصر الفاجع في 28 أيلول 1970، والانقلاب على نظام البعث التقدمي في سورية في 13 تشرين الثاني 1970 ، ثم رحيل الرئيس بومدين غير المتوقع، والمشبوه؟! بعد ذلك في 27 ديسمبر 1978.
ومن الأمثلة القريبة، التدخلات الامبريالية والصهيونية المتواصل في لبنان، واضطرار القوات الأمريكية والفرنسية إلى الانسحاب، بعد العمليات (الاستشهادية) البطولية الشهيرة، التي دفنت عدداً هاما من تلك القوات تحت الأنقاض. وأخيراً، اضطرار مشاة البحرية الأمريكية إلى الانسحاب، أيضا من الصومال، أمام مقاومة فصيل الجنرال عيديد، رغم غرق هذا البلد العربي الممزق المنكوب في حرب أهلية مدمرة ومتواصلة، دون أن تبذل “الجامعة العربية” (المخدرَّة والمخدِّرة)، أو أية دولة عربية- وخاصة مصر العمود الفقري للأمة- أية جهود ملموسة لإيقافها، وتحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن استعادة وحدة الصومال، ومكانه الهام في الجسد العربي، ودوره الاستراتيجي الخطير بالنسبة للأمن القومي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي..الخ.
وأمثلة التدخل الاستعماري الرجعي -أكثر من أن تحصى عبر التاريخ- كما حدث في روسيا إثر اندلاع ثورة أكتوبر 1917، وفي الصين ضد الثورة الاشتراكية بقيادة ماوتسي تونغ، وعملية خليج الخنازير الفاشلة في كوبا الثورية الصامدة وغيرها من التدخلات الامبريالية الأمريكية المباشرة – وغير المباشرة- لضرب وإسقاط العديد من الأنظمة التقدمية في أمريكا اللاتينية. وهكذا، طالما أن الصراع بين قوى الحرية والديمقراطية والتقدم والسلام العادل وبين القوى الامبريالية المستغلة مستمر، حتى زوال الامبريالية من العالم.
ولكن الخوف المضخم من تلك الاحتمالات، إلى درجة السلبية والشلل الذي قد يصل إلى حد اعتبار الامبريالية قدر أبدي لا يقاوم شيء؛ وشيء آخر ضرورة أخذها بالحسبان، ودراستها بمنتهى الجدية والدقة والشعور بالمسؤولية، لتفاديها والتحصن ضدها، وكيفية مواجهتها وإحباطها، إذا وقعت.
ومن الجدير بالذكر، أننا كنا – كبعثيين جامعيين- في تلك الفترة، مع استلام الحزب للسلطة، وضد إعادة الاعتبار للحزبين الرجعيين (الوطني والشعبي) اللذين أفرغا الاستقلال الوطني من مضامينه الحقيقية، وسبب كل الكوارث التي سهلت قيام تلك الانقلابات العسكرية المشبوهة.
ومع عدم نفينا لتلك المخاطر، التي طرحتها القيادة إذ ذاك، إلا أننا – مازلنا- مجدداً وعلى ضوء وعينا الراهن، ومراجعتنا لتجارب شعبنا الماضية، وتجارب الشعوب الأخرى الهامة، على رأينا السابق.
فمثلا: عندما قام “لينين” وحزبه الشيوعي بتفجير ثورة أكتوبر، كانوا أقلية صغيرة نسبياً، ولكن الشعب والجيش قي روسيا القيصرية، كانا ناضجين للثورة، لذلك استطاعت الصمود ودحر التدخل الامبريالي الرجعي.
ويمكن القول أن عملية إسقاط نظام الشيشكلي الديكتاتوري، لم تكن (انقلاباً عسكرياً) تقليدياً معزولاً، كبقية الانقلابات التي تقوم على الجيش فقط، بل حصيلة ثورة شعبية شبه شاملة، تدرجت في التصاعد خلال أربع سنوات من النضال المنضج المتواصل، وصولاً إلى الذروة التي توجت، بانضمام الضباط البعثيين وحلفائهم إلى الشعب لحسم الموقف.
وبالتالي كانت الجماهير ناضجة لعملية التغيير الجذري، وإسقاط حكم الطبقات الإقطاعية البرجوازية السابقة، واختصار مرحلة تاريخية هامة (ولا أقول حرق المرحلة). وكان من حق الحزب وواجبه استلام السلطة، كقائد لتلك الثورة: بشقيها الشعبي والعسكري المتكامل، خاصة وأن الحزب كان -خلافا لتخوفات القيادة- في أفضل حالاته، (بعد أن حصل الدمج بين حزب البعث والعربي الاشتراكي) وأنصاره في أتون النضال، والخبرات التي اكتسبها في العمل السري لأول مرة في تاريخه، وكان يتوفر على أعداد من العناصر المؤهلة، أكثر من الفترات اللاحقة التي أقدم فيها على استلام السلطة بعد ذلك، حيث كان قد تعرض للتمزق والكثير من نزيف الكوادر، ذلك أن السلطة –كما هو معروف للعالم أجمع- مطلب كل حزب سياسي، لا كغاية بحد ذاتها، بل كأداة لتحقيق البرنامج الذي يواجه الحزب، الذي هو بالنسبة لحزبنا: البرنامج الوطني – القومي – الديمقراطي في تلك المرحلة.
صحيح أن الثورة ليست “مغامرة حمقاء”، و لكن صحيح أيضاً أنها ليست (شركة ضمان و تأمين على الحياة)، بل هي عملية تغيير جذري ينقل المجتمع بأسره إلى الأمام، يجب أن تكون محسوبة بأكبر قدر من الدقة والشعور بالمسؤولية التاريخية. وأن القضية العادلة التي تحملها، و كونها تعبر عن مصالح جماهير الكادحة، وباتجاه التاريخ التقدمي الإنساني، يعزز من فرص واحتمالات انتصارها. ذلك أن المحاذير قائمة باستمرار في الصراع بين ما تعتبره القوى المعادية (محرمات) بالنسبة لمصالحها، لا يجوز أن تمس بأي حال؛ وما نعتبره نحن كأمة عربية مكافحة (المقدسات) التي ترتبط بتحرر، وتوحد، وتقدم الأمة ومشروعها الحضاري الإنساني المعاصر.
ولهذا لابد من المسارعة إلى القول: أن قبول تلك (المخاطرة) التي لابد منها لتحقيق أهداف الجماهير، لا يعني احتكار الحزب للسلطة وتفرده بها بأي حال، بل إنهاض “جبهة وطنية ديمقراطية عريضة”، تضم كل القوى الحية في القطر، تنبثق عنها (حكومة ائتلافية) بقيادة الحزب وحلفائه التقدميين، كونه هو الذي قاد عملية التغيير (وليس بقيادة القوى الرجعية) تتولى الإشراف على انتخاب “هيئة تأسيسية” وفق قانون انتخابات ديمقراطي، وتضع دستوراً تقدمياً للبلاد، ثم انتخاب مجلس نيابي حر وحكومة جديدة- وفقاً لذلك- تطبق برنامج المرحلة الوطني الديمقراطي.
فإذا كان من الخطأ والخطر، استلام الحزب للسلطة واحتكارها كلية في أي وقت -ضمن ظروف وطننا العربي المعقدة والصعبة المعروفة- فقد كان من الفاجع –بالمقابل– إعادة تسليمها مجاناً، للقوى الرجعية المجربة التابعة.
ولعل المثال العملي لكسر احتكار الرجعية، رغم بعده الشاسع عن هذه الصورة الجبهوية الديمقراطية التقدمية المذكورة أعلاه، هو قيام “التجمع الوطني” و”الحكومة القومية” على أساس ميثاق الحكم القومي عام 1956 بمشاركة الحزب، الجزئية والوصول من خلال ذلك (بالمضافرة بين نضال الرفاق الوزراء داخل تلك الحكومة، ونضال الرفاق نواب الحزب وأصدقائهم داخل البرلمان، وضغط الحركة الشعبية المتصاعدة بقيادة الحزب، بالإضافة إلى دعم ومساندة ضباط الحزب وحلفائهم القوميين التقدميين) إلى (جرّ) الحزبين الرجعيين (الوطني والشعب)، والسياسيين المستقلين، إلى رفض ومحاربة كل المشاريع الاستعمارية التي كانت مطروحة، والموافقة الإجماعية على الوحدة مع مصر.
وهكذا، فإن معظم المشاركات الأخرى في العديد من الحكومات كانت مفيدة ومجدية في حينها، كحكومة سليمان النابلسي الوطنية في الأردن سنة 1956، إبان مرحلة النهوض القومي، حيث تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية، وتطهير الجيش الأردني من غلوب باشا ومجموعة الضباط الانجليز.
كما شارك في الحكومة الوطنية العراقية الائتلافية بعد ثورة 14 تموز 1958، وفي معظم الحكومات التي قادت الكفاح لتثبيت النظام الجمهوري، ثم الوصول إلى السلطة بعد (حركة 8 شباط / 14 رمضان 1963) في العراق، وسقوطه من الداخل بالردة التشرينية الأولى 1963، وكذلك بالنسبة (لحركة 8 أذار 1963) وسقوط سلطة في سوريا بالردة التشرينية (الثانية) 1970 من الداخل أيضاً.
وقد حقق وجود الحزب في السلطة (جزئياً، أو كلياً) في معظم تلك الفترات إنجازات وطنية وقومية تقدمية هامة جداً – كما سنرى – كما اكتسب خبرات عملية ثمينة، سوف تنير طريقه في المستقبل.
* والخلاصة التي نود ذكرها في هذا المجال، الذي يحتاج إلى المزيد من الدراسة والمتابعة الجدية الدقيقة والمسؤولة من كل قوى التغيير الديمقراطي الحية في وطننا العربي هي: إن عملية التغيير الديمقراطي الجذري في قطر عربي قد أصبحت –حالياً- أكثر صعوبة وتعقيداً، إلى درجة قد يبدو أنها شبه مستحيلة تقريباً، حيث تستمر معظم – إن لم يكن جميع – الأنظمة العربية من (جمهورية) و (ملكية) جاثمة على صدر الشعب منذ أكثر من ربع قرن(2).
وحتى الآن، في واقع الانسداد السياسي المطبق بفعل (مخطط التسوية – التصفوية والاتفاقات الاستسلامية) المدمرة التي أفرزها، وما يلحق به من مشاريع “شرق أوسطية” وغيرها، كنقيض “للمشروع العربي الوحدوي الديمقراطي – الاشتراكي الحضاري – وعلى حسابه، بحيث يبقى خطر التدخل المباشر، والمتعدد الأشكال والأساليب، مصلتاً كالسيف الجهنمي ضد قيام نظام وطني ديمقراطي حقيقي، في أي قطر عربي، يسعى لتحقيق التنمية الوطنية الحديثة المستقلة، وامتلاك ناصية العلوم والتقنية المتطورة، وذلك بحجة أن ذلك يشكل خطراً على أمن (إسرائيل)!.. وكذلك الحال بالنسبة لأية خطوات وحدوية بين قطرين عربيين أو أكثر بالذريعة ذاتها، بما (يقنن) التدخل الصهيوني الامبريالي الذي يهدف إلى تأبيد التجزئة والتخلف والاستغلال والنهب لوطننا العربي، ويلقي بأمتنا خارج التاريخ الإنساني المعاصر.
ومع ذلك، فإن المبالغة في التخوف والركون إلى العقلية الانتظارية السلبية العاجزة يعني الاستسلام لواقع الهيمنة الامبريالية الصهيونية وأتباعها من الأنظمة العربية الرجعية والديكتاتورية؛ فلا معجزة خارج نضال الجماهير المنظمة وطلائعها التقدمية، التي يجب أن تقبل هذه المخاطرة التي لابد منها، والتي يجب أن تكون مركز تفكير واهتمام القوى العربية الحية -كما ذكرنا- فتبادر إلى إنهاض جبهاتها الوطنية الديمقراطية العريضة في الأقطار المعنية، وجبهتها القومية الديمقراطية الموحدة على المستوى العربي كله، بمشاركة القوى القومية الاشتراكية والإسلامية، واليسارية (الماركسية)، والليبرالية الوطنية المنتجة، وأن تسعى إلى التعاون والتحالف مع القوى الديمقراطية المحبة للعدل والحرية في العالم، وتتصرف بحكمة وعقلانية ورؤية محسوبة في العلاقات الخارجية، مع وضع خطة عملية لتحصين التغيير المنشود في أي قطر: بالتزام الديمقراطية كنهج شامل في العمل والحياة، ووجود أحزاب ثورية مؤهلة ومتحالفة في جبهة وطنية عريضة، ترسخ الوحدة الوطنية الطوعية، وتتولى تنظيم وتسليح الجماهير ومنظماتها الشعبية، وتحويل الجيش إلى جيش وطني- طبقي تقدمي مضمون، وملتزم بالشعب ومؤسساته الدستورية المنتخبة ديمقراطياً، وفق البرنامج السياسي الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي للنظام الجمهوري الديمقراطي الجديد، بحيث يتحول القطر المعني إلى قلعة منيعة، صعبة الاختراق، لن يخرج منها (بسلام) من يفكر في العدوان عليها.
وأخيرا لا بد من التأكيد الحازم على تبني حزبنا، وخاصة بعد المؤتمر القومي الحادي عشر صيف 1980، للتغيير الديمقراطي السلمي، باعتباره الأسلوب الحضاري الأمثل للتداول على السلطة، طالما كان ذلك ممكناً ومتاحاً، وإلاّ فعن طريق الانتفاضة الشعبية في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية. ذلك أن أسلوب التغيير يرتبط بطبيعة النظام القائم بالذات.
5- دور الطلاب في مقاومة ديكتاتورية الشيشكلي:
من الاستنتاجات الهامة في تلك الفترة أن نشير إلى دور الطلاب الطليعي، حيث كانت جامعة دمشق، مركز الحركة الثورية ومنطلق الإضرابات والمظاهرات التي كانت تمتد إلى ثانويات ومدارس القطر، ومن ثم في المراحل المتقدمة، إلى جماهير العمال والفلاحين والحرفيين وصغار التجار؛ وأهمية هذا الدور -حتى الآن- خاصة في البلدان المتخلفة التي لم تتبلور فيها – بعد- طبقة عاملة طليعية واعية منظمة وقوية: كماً ونوعاً، مع وضع فلاحي بائس في ظل الإقطاع والعشائرية وتحكم أجهزة الدولة، وتطور هذا الدور إلى صيغة: تحالف المتثقفين الثوريين عامة، مع العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة والجنود، واعتباره بمثابة (الصاعق المفجر) للثورة داخل هذه الكتلة الشعبية التاريخية الهائلة، التي هي الأساس في عملية الحسم الثوري الظافر، والتي بدون مساهمتها الحقيقية تبقى الطليعة الثورية المثقفة مهددة بالعزلة، بما يسهل على القوى المعادية محاصرتها وتصفيتها.
– تجربة النضال ضد نظام الشيشكلي الديكتاتوري، خلال فترة غياب الأساتذة الثلاثة (ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأكرم الحوراني) خارج القطر:
إننا إذ نضع هذه الفقرة، كأحد الاستنتاجات الهامة، لتجربة الحزب في تلك الفترة النضالية الجيدة، فلأنها ذات معاني عميقة ودلالات معبّرة عن حقيقة الحزب، وطاقاته الكامنة الكبيرة، ودور قيادته (التاريخية) في أزماته في التعامل مع (الانقلابات)، وبمجرد الاقتراب من السلطة؛ ذلك أن القيادات (التالية)، أو قيادات الصف الثاني-كما تسمى عادة- مع أن معظمها من المؤسسين- وكذلك كوادر الحزب المتقدمة، وقواعده المناضلة عامة، قد برهنت نظرياً، وممارسةً، على إبداعاتها وقدراتها الخلاقة، وجرأتها الرائعة، ووضع المطالب الشعبية المرحلية الصحيحة الواضحة التي طرحها الحزب في بياناته التي صدرت في تلك الفترة (وأوردنا بعض نماذجها فيما سبق)، حيث تجلّت عبقريتها في إدارة الصراع طيلة حوالي عامين كاملين، بوعي أعلى، وشجاعة أشد، ومبادرات أذكى وأساليب أكثر فاعليةً وتنوعاً، من فترة وجود (القيادة التاريخية)، مما جعل الحزب قائد النضال الشعبي الأول في القطر باعتراف الجميع، الأمر الذي جعله يشعر بأنه يمكن أن يسيّر بشكل أفضل (بدون تلك القيادة)، التي بدأ البعض يظن بأنها كانت أحياناً، عبئاً على نضال الحزب الذي أصبح بإمكانه الاستغناء عن استمرارها في قيادته.
فقد برهنت تلك التجربة المضيئة على قدرة بقية (القيادات) والكوادر الحزبية على قيادته في غياب (الأساتذة)، وأفرزت طاقات حزبية نضالية متميزة، كان يجب أن تفخر بها تلك (القيادة التاريخية)، وتستوعبها، وتشجعها، فلا تعود، بعدها، إلى استمرار فرض وصايتها الأبوية الخانقة على الحزب، وترهن مصيره، كحركة ثورية كبيرة متنامية، يحمل رسالة الأمة، بحدود سقف وعيها الخاص، ومصيرها الشخصي فقط، بل كان من الطبيعي أن تشعر بالسعادة والاعتزاز لذلك التطور، كما يشعر (الأب) الحقيقي بالغبطة عندما يتفوق عليه أبناؤه، بما يقدمه لهم من عناية، وكأمر طبيعي منتظر ومرغوب، تبعاً لفعل الزمن ومعطياته المستجدة. وكان من الأفضل لو أفسح (الأساتذة) المجال لتلك القيادات الكفوءة، التي برزت خلال المعركة، لتتولى قيادة الحزب، أو الدور الأساسي في قيادته -على الأقل- مع بقاء الأساتذة فيها -دون تمييز- أو كرموز شرفية، وروحية للحزب.
هوامش:
- قرأت كتاب السيد مصطفى دندشلي “حزب البعث العربي الاشتراكي” في بداية عام 1997، وأنقل عنه هنا، هذا المقطع، حول موقف الأستاذ أكرم من استلام السلطة، بعد إسقاط الشيشكلي 1954، الذي يقول أنه أخذه منه في مقابلتين أجراهما “المؤلف” مع الأستاذ أكرم في آب (أوت) 1965 بدمشق، ونيسان (أفريل) 1970 في بيروت (ص 168-196)، وهو يؤكد ما ذكرناه حول هذا الموضوع من تحليلات وأسباب ومواقف في “الجزء الأول” من: “دراسة اولية حول نقد تجربة الحزب” (ص 76-80) = حول: عدم استلام الحزب للسلطة – ومسألة عدم جاهزية الحزب، والخوف من التدخل الأمريكي-البريطاني- العراقي، إذ ذاك، وذلك قبل اطلاعنا على هذا الحديث الواضح:
…<إن مجرد التفكير باستلام السلطة في تلك الظروف كان بالنسبة إليه (أي للأستاذ أكرم) ضرباً من المغامرة الهوجاء، أكثر منه وسيلة لإقامة نظام تقدمي شعبي. ويؤكد أن التحليل البسيط للوضع السياسي في تلك المرحلة كان يظهر بوضوح وجود عوامل تحول دون تحقيق هذا الأمر. أولاً، العوامل الخارجية: لو أخذ البعث السلطة عنوة لكانت سورية تعرَّضت جدياً لغزو خارجي وبالدرجة الأولى من العراق. ثم أن الوضع الدولي لم يكن مواتياً لمثل هذا العمل. فالحرب الباردة كانت آنذاك في أوجها. والأكثر من ذلك كانت مصر في ذلك الوقت على علاقة طيبة مع الغرب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة، وكان موقفها من الانقلاب الذي أطاح بنظام الشيشكلي موقف عداء عنيف، فديكتاتور سورية كان بالفعل على وفاق تام مع النظام المصري الجديد.
وأخيراً، فإن العقبة الكأداء أمام استلام السلطة كانت ضعف البنية الداخلية للحزب، والنقص في كوادره.
وما أكده الحوراني أيضاً هو أن الحزب لم يعدم الفرصة لاستلام الحكم:
“فالطريق إلى السلطة كانت مفتوحة أمامنا منذ 1950 (أي منذ تأسيس الحزب العربي الاشتراكي)، وحتى تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. غير أننا في ذلك الوقت، كنا نهدف إلى تقوية وتنمية الحركة الشعبية الثورية الوحدوية والتقدمية. لقد كانت إستراتيجيتنا تستهدف خلق وتوسيع حركة الجماهير، بالاعتماد من أجل ذلك على العناصر التقدمية في الجيش”>. “انتهى النص”
• لقد حلّلنا هذه المسألة مفصلاً في مكانها الخاص من الكتاب (ص 62-67): 4 مسألة استلام السلطة وأود أن أضيف هنا: أن تحول “حزب الشباب” إلى “الحزب العربي الاشتراكي”، بعد المهرجان الفلاحي الضخم في مدينة حلب عام 1950، كان كما يقول البعض “بتشجيع من الشيشكلي، وأنصار الأستاذ أكرم من ضباط الجيش ” <المصدر ذاته ص 154>.
ويمكن الإستنتاج، من حديث الأستاذ أكرم بالذات، أنه ربما كان من المقدر أن يكون “حزب السلطة”، وأن إعلانه تم في هذا الإطار، أثناء المرحلة الأولى لانقلاب الشيشكلي ضد “حزب الشعب” وبتشجيع من الأستاذ أكرم. ولكن تغير الموقف، بعد الخلاف معه، في المرحلة الثانية من انقلابه، حيث افتضح اتجاهه الديكتاتوري المشبوه، مما جعل الأستاذ أكرم وحزبه يتنقلان إلى معارضة الشيشكلي، وصولاً إلى الاندماج مع البعث في خضم النضال ضده، باسم (البعث العربي الاشتراكي).
كما نود التوضيح أن ما قاله الأستاذ أكرم عن موقف عبد الناصر ونظامه الجديد، من نظام الشيشكلي وتأييده له ومعاداته للبعث، كان صحيحاً في تلك المرحلة حتى 1954، ولكن الوضع تغير بعد ذلك من خلال المعارك المشتركة ضد الأحلاف الإمبريالية الرجعية. وفي عام 1957 “إبان حصار قطنا” كان البعث وعبد الناصر قد أصبحا صديقين، وبالتالي فإن التخوف الذي ذكره الأستاذ أكرم عندئذ ليس صحيحاً. بالإضافة إلى تطور العلاقات السورية مع الاتحاد السوفياتي –رغم أن استلام السلطة عن طريق الانتخابات الديمقراطية، عامة، أفضل وأضمن، طالما أمكن ذلك.
2- ملاحظة: كتبت هذه الفصول في ثمانينات القرن الماضي.
 البعث الديمقراطي
البعث الديمقراطي