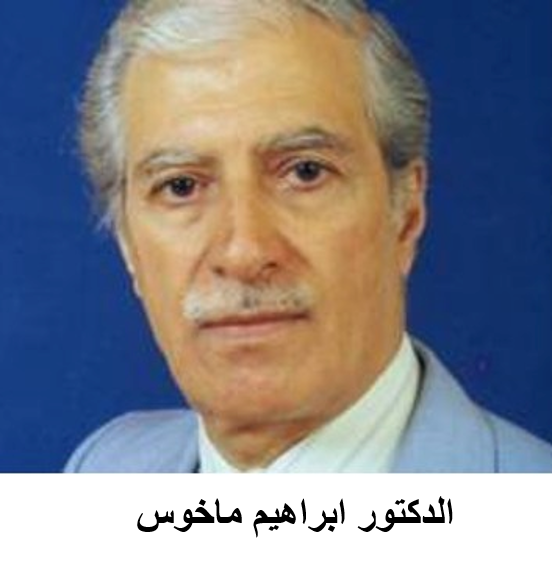
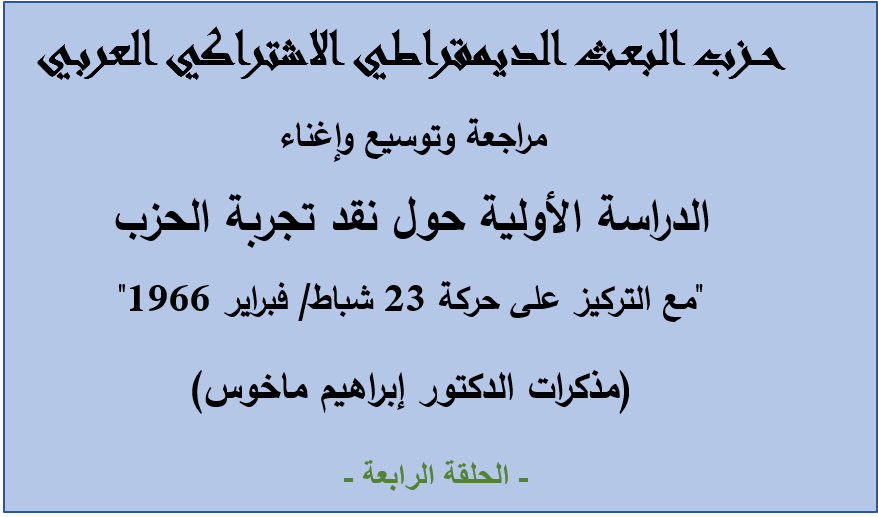
* الغاية والوسيلة- والممارسة الأخلاقية في الثورة والدولة:
لقد تميز التاريخ العربي الحضاري بحرص الطلائع المكافحة من اجل التقدم، على تجسيد الأفكار والشعارات والقيم الأخلاقية المطروحة.. ولعل ظهور جميع الأنبياء حملة الرسالات السماوية، في وطننا العربي بالذات، كنماذج حية للمثل الأعلى الإنساني الأرقى، لدليل واضح على ان شعبنا لا يثق بمجرد الكلام، ولا يؤمن بالشعارات والأفكار والبرامج المطروحة، مهما كانت رائعة، ما لم يمارسها دعاتها سلوكاً عملياً ملموساً في واقع الحياة. وبعبارة اخرى، فإن تطابق الطرح الصادق الصحيح مع الممارسة الصادقة الصحيحة، على مستوى الأفراد، أو الحركات والأحزاب، شرط لاكتساب اقتناع الجماهير، واكتساب ثقتها واحترامها، واستجابتها لذلك؛ علماً أن هذا التطابق المطلوب يبقى نسبياً، في معظم الأحيان، وفقاً للمرحلة الزمنية والظروف الذاتية والموضوعية المحيطة.
ومن الصعب أن يكون كاملاً إلاّ في مراحل الصعود الثوري والرسالي، وبالنسبة للطلائع الثورية الحقيقية الأكثر وعياُ وإيماناً برسالة الثورة؛ لأن البشر عامة عاجزون عن تجسيد المطلق. وهذا يعني أن الوسائل يجب أن تنبثق من الأهداف، فالغايات النبيلة يجب أن يكون العمل لتحقيقها بوسائل وأساليب نبيلة من طبيعتها.
• ومن البديهي، أن يتم التعامل بهذا النهج الأخلاقي مع الشعب بكل نزاهة وإخلاص وإستقامة وشرف وصدق وديمقراطية وتواضع.. إلخ، أي بكل القيم الفاضلة. وكذلك الحال مع الأصدقاء وجميع البشر العاديين في العالم بأسره.. أي فقط باستثناء القوى المعادية مباشرة للوطن والأمة؛ ذلك أن هذا النهج لا يمكن أن ينطبق على التعامل مع العدو الإمبريالي الصهيوني المحتل الذي يغتصب حقوق الوطن والأمة، ولا يتورع عن استخدام أية وسيلة على الإطلاق لتحقيق أهدافه العدوانية ومصالحه الأنانية وغير المشروعة على حساب حرية وكرامة ومصالح شعبنا ومصيره بالذات.. فلا نظن – في هذه الحالة وحسب كل تجارب التاريخ- أن أحداً يقابل سيف العدو بغصن الزيتون، وقنابله الفتاكة وصواريخه المدمرة بنثر الورود والرياحين. ولابد من معاملة العدو بمثل أساليبه وسلاحه، بل وبأساليب وأسلحة أكثر فعالية -إن أمكن ذلك- وفقاً لكل قوانين الأرض والسماء.. كما تقول الآية: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم” والآية: “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”، وكما قال الخليفة عمر بن الخطاب: “والله ما أنا بالخبِّ ولكن الخبَّ لا يخدعني”.
• والمشكلة أن العنف الذي رافق جميع ثورات العالم ولا يزال، لم يقتصر على مرحلة الثورات فقط، حيث يواجه الثوار عنف الطبقات الرجعية المعادية بعنف مماثل لابد منه، بل تجاوزها إلى المجالات الداخلية العادية في إطار الدولة، حيث أصبح سمة ثابتة رهيبة لمعظم –إن لم نقل لجميع- الأنظمة العربية الحالية؛ كما لم تنج منه – وإن بأشكال نادرة وعابرة- حتى الأنظمة التقدمية السابقة.
أما بالنسبة للصراعات التي دارت، ويمكن أن تدور، داخل الحزب الواحد، أو المجموعات الحاكمة- كما حدث مع حزبنا بالذات- خلال مرحلة “الإزدواجية” وصولاً إلى المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي.. فالردة على الحزب ونظامه التقدمي، تحتاج للمراجعة والتأمل، حيث تعاملنا مع قيادة الجيش المتمردة بالأساليب الحزبية النظامية الديمقراطية (المثالية) مقابل تعاملها مع الحزب بالأساليب الانقلابية الدكتاتورية (كما سيرد مفصلاً فيما بعد).
وبالتالي- وهذا نوع من التكرار لحوادث مشابهة في التاريخ –فإن الوسائل لم تكن متكافئة ولا متماثلة بين الطرفين، سواء داخل الحزب الواحد –حسب مثالنا المذكور- أو داخل الشعب الواحد والوطن الواحد أو الدين الواحد، في تلك الحوادث التاريخية الأخرى.
الطرف المحق الذي يسعى لغاية نبيلة، ويصر على استخدام الوسائل الديمقراطية والسلمية الشريفة لتحقيقها؛ والطرف الآخر الظالم المغتصب الذي يسعى بالباطل إلى هدف شخصي مصلحي سيء ومناقض لمصلحة الوطن والشعب والقضية، ويستخدم كل الوسائل اللاأخلاقية الشريرة والماكرة والعنيفة للوصول إليه.
والنتيجة، هل تعني هذه التجارب التاريخية أن (المثاليين) غير مؤهلين لاستلام السلطة التي يستحيل أن تكون (مثالية) وبدون حدّ أدنى من (القذارة في ظل وحدانية السلطة)؟…إلاّ، ربما، بعد وصولها إلى مراحلها العليا، أي: الديمقراطية الاشتراكية..
وأذكر في هذا المجال جملة معبّرة قالها لي أحد الأخوة الجزائريين، باللغة الفرنسية:
« Il n’y a que dieu qui peut être puissant et juste »
أي “لا أحد سوى الله يمكن أن يكون قوياً (أو قادراً) وعادلاً في الوقت نفسه”… وكان يقصد أن السلطة لا يمكن أن تكون عادلة مائة بالمائة.
ويبدو أن كتاب “الأمير”، الذي ألفه “نيقولا ماكيافلي” في القرن السادس عشر، قد أصبح مرجعية و(دستوراً) لمعظم الحكام منذ ذلك الحين وحتى الآن، علماً أن (مقولاته) ليست جديدة، بل رافقت البشر منذ فجر التاريخ.. ويقول بعض الدارسين أنه ظلم، لأن هدفه كان نبيلاً، وهو توحيد بلده إيطاليا، وتحريرها من المرتزقة والغزاة الأجانب.. وقد وضع ذلك الكتاب (كدليل نظري وعملي) للأمير الإيطالي المنقذ.. “الذي يجب أن يكون بطلاً وطنياً شجاعاً يتصف بالدهاء والمكر والحيلة الواسعة… ويستخدم كل الوسائل..” ضد الأعداء السفلة الذين لا تجدي معهم الأساليب الأخلاقية، انطلاقاً من أن “الغاية تبرر الوسيلة”، حتى أصبحت صفة “الميكافيلية” نوعاً من الشتيمة) السياسية كونها تكثف كل المعاني السيئة والصفات اللاأخلاقية والأساليب الشريرة الماكرة الخبيثة والوحشية.. إلخ، وعدم تورع من يتصف بها عن أي شيء على الإطلاق في سبيل تحقيق أهدافه وغاياته المرسومة.
ورغم ذلك كله- وبغض النظر عن الوسائل المتبعة- يمكن القول إن بعض الحكام قد استعمل “الميكافيلية” – وما يزال- لخدمة وطنه وتحقيق مصالح أمته.. بما يمكن اعتباره (وجهاً إيجابياً) “للميكافيلية”.
خلافاً لما يحدث في وطننا العربي ومعظم بلدان العالم الثالث المبتلاة بأنظمة حكم رجعية ديكتاتورية، فحتى هذا (الوجه الإيجابي) النسبي غير موجود؛ بل يمارس هؤلاء الحكام (الشطّار فقط في سحق شعوبهم)، ما يمكن تسميته بـ (الميكافيلية المبتذلة) أو المقلوبة، أي استخدام (وصفاتها) السيئة القاتلة في التعامل مع شعوبهم بالذات، وفي ما بينهم، داخل الأمة الواحدة والوطن العربي الواحد…وليس ضد الأعداء من القوى الإمبريالية والصهيونية الغازية والمستغلة النهابة التي أصبح معظمهم يضع (ثقته) بهؤلاء الأعداء.. ويراهن على (حسن نواياهم).. ويسلّم، علناً، بأنهم يمسكون بـ 99% من أوراق (عملية الصراع العربي-الصهيوني).. مقابل 1% للأمة العربية كلها ومعها كل القوى والدول الصديقة والمحبة للحرية والعدالة في العالم.. وهكذا يربطون مصيرهم بهؤلاء الأعداء، ويهرعون للتصالح معهم، والالتحاق بخدمتهم مقابل حماية تسلط هؤلاء الحكام – كوكيلة لهم- على الشعب الذي يعادونه ويخافونه، ويستخدمون تلك (الميكافيلية) المبتذلة المقلوبة لإذلاله وقهره وإفقاره وتجهيله وتهميشه وقتل مناعته الوطنية والقومية.
وبالتالي، أوليس من حق هذه الشعوب المبتلاة، في مثل هذه الحالات – بل من واجبها- وواجب قواها الوطنية الديمقراطية المعارضة، أن تستخدم – بالمقابل- كل الوسائل والأساليب المتاحة للتحرر من هذه الأنظمة الطاغية العميلة؛ رغم أننا نفضل – مبدئياً- وسائل النضال الديمقراطي السلمي – طالما أمكن ذلك- وكان التغيير الديمقراطي متاحاً…
ثم، وبعد هذا كله –ألا تفسّر- ولا نقول تبرر- هذه (الميكافيلية) المبتذلة الوحشية التي يمارسها بعض الحكام، ردود الأفعال العنيفة الوحشية المقابلة التي تمارسها بعض القوى (الإرهابية) المتطرفة المعارضة التي لا تطرح أي برنامج سياسي ديمقراطي بديل.. والتي لن تؤدي، واقعياً، إلى اي تغيير ديمقراطي للأنظمة القائمة المعنية، بل تضع الشعوب المنكوبة بها، بين أسنان منشار السلطة والإرهاب المزدوج في آن واحد.. الذي يأكل لحم الشعبويقطع أوصاله.
•ونختم بالقول- ومهما كانت التجارب التاريخية والمعاشة مريرة وبشعة- سواء في التعامل (الميكافيلي) داخل الوطن الواحد: بمختلف مكوناته الاجتماعية وأنظمته السياسية؛ أو ما بين شعوب ودول العالم أجمع.. فإن طموح جميع المناضلين من أجل حرية وكرامة الإنسان، ودعاة الإصلاح وذوي النوايا الحسنة من البشر، ناهيكم عن الأديان السماوية والفلسفات الإنسانية الوضعية منذ القدم وحتى الآن، كان –ولا يزال- هو الوصول إلى عالم إنساني فاضل تحكمه القوانين الأخلاقية، التي تكرس قيم الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة والمحبة وكافة حقوق الشعب والإنسان الأساسية المعروفة التي أصبحت مقرة ومعتمدة عالمياً –(نظرياً على الأقل)… فبذلك وحده “نكرم الإنسان”، وتصبح الحياة جديرة ان تعاش.
– وإني، إذ أستدرك فأسارع إلى القول بأن عالمنا الحالي يمثل الصورة البشعة النقيض التي تبدو للكثيرين، من فرط ظلامها وظلمها وقسوتها وانسداد آفاقها، أنها العبودية الأبدية.. أؤكد، فوراً، ومن جهة أخرى، إيماني المطلق بأن هذا الواقع العبودي الإنساني الرهيب ليس قدراً أبدياً لا فكاك منه. وانه يحمل عوامل انهياره في ذاتهعبر تناقضاته العديدة الهائلة المتفجرة. ويستحيل استمراره كنظام للبشرية بأي حال.
وأن حلم البشر (السرمدي) بالعالم الذي ذكرته ليس وهماً، فثمة فرق كبير بين الحلم الثوري المشروعوالوهم الذاتي العاجز، وكذلك بين (الواقعية الإستسلامية) و(الواقعية الثورية).
وبالطبع، فإني لا أتوهم، وغيري من المناضلين، أن هذا الحلم سيتحقق غداً، و(كلياً) أو في الأفق القريب، وحتى المتوسط، كونه يحتاج إلى نضال ثوري (طبقي وقومي) عالمي جديد، وتضحيات هائلة، ربما تفوق كل ما عرفته البشرية حتى الآن؛ كي يبدأ فجر النقلة النوعية القادمة على طريق تحقيقه التدريجي، في الأوطان الأكثر تأهيلاً وجدارة ونضجاً، ريثما يعم العالم في المستقبل البعيد.
* ميزان القوى:
يبدو من خلال الاستعراض التاريخي (الوصفي) أو (السردي)، أن “ميزان القوى” كان-ويكون- دائماً، أو غالباً، في البداية، لصالح الظلم والباطل، ضد المظلوم والحق، منذ (قابيل وهابيل) وحتى الآن، ولكنه يتعدّل ثم ينقلب لصالح المظلومين وأصحاب الحق طالما أصرّوا على التمسك بحقهم، وعملوا على التخلص من الظلم، الأمر الذي تؤكده مسيرة التاريخ الحضارية المتواصلة.
كما يوضح التحليل العلمي، الأهم، لتطور المجتمعات البشرية أن الصراع الطبقي الدائر، دائماً وأبداً – بهذا الشكل أو ذاك- بين الطبقات المسيطرة المستغلة الظالمة، التي تتمترس في الوضع المتخلف القديم؛ وبين الطبقات التي تمثل المرحلة الجديدة المتقدمة المنبثقة من قلب النظام القائم، لتغييره وتجاوزه نحو نظام طبقي أفضل… هذا الصراع الذي سيستمر وصولاً إلى النظام الديمقراطي الاشتراكي الإنساني المنشود، كان يتمكن من تغيير موازين القوى القائمة –مهما بلغت من الطغيان- لصالح القوى المناضلة الصاعدة الأكثر تقدماً.. وهكذا.
– وإذا كان من الواجب حساب موازين القوى بدقة، والتزام نهج الواقعية الثورية في التعامل معها لصيانة القوى الثورية، وحسن استخدامها في عملية الصراع مع العدو، وتفادي الخسائر المجانية، بقدر الإمكان.. إلخ؛ فإن استمرار الجمود والركون إلى (العقلية الإنتظارية) السلبية كان يعني توقف حركة التاريخ التقدمية، وعدم تحرر أي شعب في العالم، ذلك أن هذه الموازين ليست سكونية، ولا هي معطى أبدي ثابت، بل متحركة وقابلة للتغيير تبعاً لنضال البشر المعنيين، ومدى وعيهم، وكيفية استخدامهم الظروف والإمكانات والمعطيات القائمة والمستجدة وفقاً لنهج الواقعية الثورية بالذات، بإيجاد الأساليب المرنة المناسبة لجدوى فاعلية ذلك النضال وتراكماته الإيجابية المتتالية… فالشعب المنظم الموحد الذي يمتلك قيادة ثورية واعية، والمصمم على التضحية والاستشهاد في سبيل قضيته، لا يمكن أن يقهر.. الأمر الذي لم يتوفر في القيادات السياسية للوطن العربي في مرحلة الردّات الحالية على الخصوص، حيث أصبحت مقولة “ميزان القوى” “كلمة حق يراد بها باطل”، وحجة للتقاعس والتخاذل والتنازلات الخطيرة والاستسلام المذهل أمام العدو الصهيوني الإمبريالي. وهو ما يذكرنا ببعض العبارات المتخلفة عن زمن الاستعمار التركي الطويل ووريثه الفرنسي اللاحق التي كنا نسمعها أحياناً، ونحن في مراحل التبشير الأولى وبدايات إنشاء الحزب، من العجزة والجهال البائسين المساكين وكذلك من الانتهازيين الخبثاء المضللين، لتبرير الواقع الفاسد والركون إليه، والتعامل معه كقدر لا يرد، ولتثبيط عزائم الشعب والمناضلين ومحاولة (نصحنا) وإقناعنا بعدم جدوى التصدي له، مثل: “العين لا تقاوم المخرز”.. و”اليد التي لا تستطيع عضها.. قبلها.. وادع عليها بالكسر”.. و”ربك وحاكمك”.. وما أشبه ذلك من (حكم) عصور الانحطاط المظلمة السابقة، والتي أصبحت تُنبش، وتُسوق، حالياً، وينظّر لها (بعض الحكام العرب) واتباعهم من أدعياء (اليسار) السابقين المرتدين.. و(الليبراليين) الوطنيين – القدماء الجدد- الذين طالما ركبوا ظهر (الثورة) سابقاً وتربعوا على عرشها المزيف حالياً بعبارات (حديثة) شكلاً، ولكن بنفس المضامين المتخلفة القديمة، تحت ستار (الواقعية) المضللة والتمترس وراء حجة التغيرات العالمية الجديدة المعروفة، بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي.. وتفرد الإمبريالية الأمريكية بزعامة العالم.. والدعوة إلى ضرورة التلاؤم مع (نظامها العالمي العبودي المتجدد) كونها تمسك بمصائر الكون، وبـ 99% من أوراق عملية (التسوية) مع العدو الصهيوني؛ وان لا خيار للعرب – بالتالي- سوى القبول بهذه التسوية الأمريكية الصهيونية المطروحة، حيث يشككون حتى بـالـ 1% المتبقية للأمة العربية بأسرها، ولكل دول العالم الأخرى المعنية والمهتمة!!!..
وهم لم يسقطوا فقط واجب مقاومة “منكر” العدو الأكبر باليد والسلاح، بل تخلوا عنه ومنعوه حتى “باللسان”. ويحاولوا قطع (لسان) المعارضين لذلك، لدرجة (تجميد) تداول الآيات القرآنية التي تتناول اليهود، وصولاً إلى انتزاع هذا الواجب القومي الملزم حتى من “قلوب” الجماهير، رغم أنه “أضعف الإيمان”. فإذا كانت موازين القوى الظاهرية غير مناسبة لمقاومة العدو الصهيوني بالسلاح، وخاصة بالحرب التقليدية، فلتترك –على الأقل- للقوى الوطنية أن تتولى توعية الجماهير بالحقائق، وتعرية العدو ومخططاته الخطيرة، وتحصينها ضدها، وتغذية وترسيخ روح المقاومة في نفوسها، وتجنيدها لإحباط هذه المخططات باللسان والسلاح مستقبلاً، بدلاً من الإمعان في تضليل وخداع هذه الجماهير بقلب الحقائق وتصوير الخيانة وطنية والاستسلام بطولة وانتصاراً، ومحاولة تدجينها وتطويعها ودفعها إلى التعايش (المستحيل) مع العدو الصهيوني، والنوم على أوهام الرخاء الاقتصادي القادم مع أنسام (السلام) الكاذبة السامة.
– ولفضح دعاة (الواقعية الإستسلامية) الخانعين لشروط العدو بحجة “ميزان القوى” إياه، لابد من توضيح الأشكال العديدة لهذه المقولة، بحيث لا يتوهم أحد أن تحقيق “ميزان القوى” بمفهومه التقليدي الشامل لأبعاده العسكرية والاقتصادية والبشرية.. إلخ، ممكن حالياً، بين أية دولة في العالم، وبين الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً.. الأمر الذي إذا كان قد تحقق بصورة ما،إبان وجود الاتحاد السوفياتي، فإنه لم يكن يعني اللجوء إلى الحرب بين تلك الدولتين التي تعني فناء الجميع.
وبالتالي، فإن انتظار الشعوب المستعمرة أو الخاضعة لهيمنة الإمبريالية حتى يتحقق لها توازن القوى التقليدي مع جلاديها يعني بقاءها – إلى أمد غير منظور- تحت وطأة الاستعمار والاستغلال. ولو طبقت هذه “المقولة” لما تحرر أي شعب في العالم الثالث حتى الآن.
ومن البديهي، أنه ما من إنسان عاقل أو حركة وطنية ثورية، يمكن أن تتجاهل واقع الزلزال الذي هز العالم بانهيار المعسكر الاشتراكي، وموجاته الارتدادية التي لم تستقر بعد.. أو تحاول التعامل مع هذا الواقع بعقلية “دونكيشوتية” – بالمعنى المادي لذلك- أي بمواجهة المدفع والدبابة والطائرة والصاروخ بالسيف والحصان والمقلاع.. إلخ.
وليس المطلوب، أيضاً، من الحركة الوطنية أن تصر على الصعود في وجه سيل عارم منحدر من الأعالي في وادي سحيق.
وللمزيد من التوضيح، وحتى لا نتهم (بالدونكيشوتية) من قبل منظري (التسوية-التصفوية) نسارع إلى القول: أن المواجهة مع العدو في حرب تقليدية بين الجيوش النظامية بهذه الأسلحة غير المتكافئة عملية (دونكيشوتية) سلبية، وانتحارية عبثية فعلاً. ولكن هذا لا يعني تقمص روح التخاذل والعبودية، والتخلي عن روح الفروسية وإرادة الحرية التي يجب استلهامها في البحث العلمي عن وسائل كفاحية مناسبة لمعطيات العصر.
لذلك فإن نضال الشعوب التحرري لا يقوم على دبابة وطائرة مقابل طائرة مماثلة.. إلخ – الأمر المستحيل عملياً –كما يعرف الجميع، بل يتخذ أشكالاً مبتكرة، مثل حروب العصابات وحروب* التحرير الشعبية الطويلة الأمد، التي تقوم على تنظيم الجماهير المسلحة بالإيمان بقضيتها، والمصممة على الكفاح في سبيلها، مهما بلغت التضحيات، وبوسائل أقل جداً من ترسانة العدو العسكرية الهائلة الحديثة، لكن اكثر فعالية، من حيث استنزافه وتدمير مصالحه (التي يقاتل من أجلها أساساً) وإضعاف معنويات جنوده، وخلخلة رأيه العام الداخلي بالذات، واضطراره إلى الانسحاب. والأمثلة الواقعية الكبرى على صحة هذه الإستراتيجية الثورية لا تحتاج لأي توضيح، حيث يمكن القول – بدون تهمة “الدونكيشوتية”- إنه يمكن قتل جنود العدو بالسيوف والخناجر، وتدمير دباباتهم بقنابل تقليدية تصنع محلياً –كزجاجة مولوتوف مثلاً- أو لغم مضاد للدبابات، وإجبارهم على الاستنفار المستمر، وإرهاقهم حتى (بسلاح الحجارة) المبتكر الذي استخدمته “انتفاضة” أطفال فلسطين الثورية، وقدمت به إضافة نوعية في تاريخ النضال الإنساني ساعدت على إيقاظ (الضمير) العالمي وبلورة قضية فلسطين كقضية تحرر وطني في العالم أجمع، أكثر من جميع الأساليب النضالية السابقة المعروفة.
والنصر في مثل هذه المواجهات الثورية لا يكون عسكرياً بالمعنى الحرفي المعروف في الحروب التقليدية بين الدول، كالحربين العالميتين الأولى والثانية، مثلاً، بل هو –كما ذكرنا سابقاً- بجعل الاحتلال الأجنبي مكلفاً، وغير مجد، وفاقداً لمبرر وجوده الاستغلالي من الأساس؛ فيرضخ ويرحل كما حصل في الجزائر، حيث لم يكن ثمة أي تناسب على الإطلاق ولو بالحد الأدنى بين أسلحة الثوار البسيطة وأسلحة الاستعمار الفرنسي البالغة القوة والحداثة، والمدعمة بالحلف الأطلسي.
– ولعله من المعبر أيضاً، أن نذكر ظاهرة “العمليات الاستشهادية” البالغة الفعالية والتأثير، كتلك التي استهدفت مقرات القوات الأمريكية والفرنسية في لبنان، واضطرتها إلى الانسحاب.
وكذلك العمليات الاستشهادية المرعبة للعدو الصهيوني في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، ثم حرب العصابات التي واجهت القوات الأمريكية في الصومال الجائع الممزق، وأجبرتها على الرحيل.. كمجرد أمثلة قريبة على تعدد وسائل الكفاح الفعالة، التي تلجأ إليها الشعوب المستضعفة المتعلقة بقيم الحرية والكرامة، في مواجهة أعتى القوى العالمية، والتي لا تتعلق “بميزان القوى” العادي، ولا تتوقف عليه؛ إذ لا يمكن للعدو المتفوق استخدام كل أو بعض وسائل قوته وأسلحته النوعية الخارقة في مواجهة مثل هذه الحالات التي يستحيل معها تفادي إقدام المجاهد المصمم على الاستشهاد في سبيل الوطن من القيام بذلك.
ومن استلهام الحزب لتجارب الشعوب الثورية ومفهومها لمسألة “ميزان القوى” جاءت إستراتيجية حرب التحرير الشعبية، التي أقرها المؤتمر القومي التاسع (أيلول 1966) لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وحماته الإمبرياليين، لعلمه بعدم قدرة العدو على مواجهة مثل هذه الإستراتيجية الطويلة الأمد، خاصة وأننا نعرف أن الحرب (الكلاسيكية) الظافرة معه غير مضمونة في الظروف القائمة، لعدم توفر البنية التحتية الاقتصادية والصناعية-العسكرية المتطورة اللازمة، كون (إسرائيل) تشكل امتدادً عضوياً للإمبريالية في المنطقة وأن معركة التحرير تحتاج – حتى لو توفر السلاح المشترى من الخارج- إلى وحدة الدول العربية، أو وحدة الدول الثلاث الأساسية: مصر وسوريا والعراق، على الأقل، وبمضمون ديمقراطي شعبي حقيقي.
هذا، مع العلم، أن مجموع الإمكانات العسكرية المتوفرة حالياً في الدول العربية ككل، تفوق ما لدى (إسرائيل) (إذا استثنينا ترسانتها النووية غير القابلة للاستخدام هكذا بسهولة من جانب واحد في الظروف الحالية). فالدول العربية، الخليجية خاصة، تعد في مقدمة الدول الأكثر شراء للسلاح في العالم بأسره (لتكديسه واستخدامه ضد الشعب، والجيران العرب، والأمة عامة، وليس ضد (إسرائيل) من جهة، وتشغيل معامل السلاح في أمريكا والغرب عامة وهدر فوائض أموال البترول – في غير محلها- وتفويت فرصة التنمية القومية الحديثة في الوطن العربي، ناهيكم عن الجوانب الاقتصادية والبشرية الهامة التي ترجح – بما لا يقاس- ميزان القوى (الموضوعي) لصالح الأمة العربية، وتكذب حجج المتخاذلين الندابين على حائط “ميزان القوى” (الطابش)، لصالح (إسرائيل).. وذلك لو توفرت الإرادة السياسية الوطنية والقومية المستقلة والمصممة على التحرير، وتحقق تصالح الأنظمة مع الجماهير، بدل تهافتها على (التصالح) مع العدو الصهيوني… وهو ما لا يمكن المراهنة عليه، في الظروف العربية الحالية، من جهة، والذي يشير من جهة ثانية، إلى أن المسألة لا تتعلق فعلاً “بميزان القوى” (الموضوعي) بحد ذاته، المجمَّد قصدا، بل بعامل تقاعس الأنظمة العربية الذاتي عن استخدام طاقات الوطن العربي المتوفرة الهائلة في مجرى التحرير، بدل التخلي عنها لصالح العدو. وهذا يحتاج إلى توفر أوضاع وطنية ديمقراطية. وعلى هذا الطريق وريثما يتم ذلك، يجب الحرص على استمرارية الثورة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية*** بعلاقاتها الكفاحية الصادقة بعمقها القومي الشعبي، وتغذية الروح الاستشهادية بما يؤدي تدريجياً إلى إجبار هذه الأنظمة على تقديم الدعم المطلوب ولتغيير العديد من الوقائع والمعطيات والتفاعلات في المنطقة التي تساعد على استنهاض الجماهير وصولاً إلى إرهاق العدو الصهيوني المحتل، وتعرض مصالح حماته الإمبرياليين للخطر، وإفشال المخطط التصفوي بما يسرع في إنضاج وقيام التغيرات الديمقراطية المنشودة التي يمكن معها – فقط – الوصول إلى الحل المرحلي الوطني والقومي المتوازن الذي يحرر الأراضي العربية المحتلة، ويحقق الأهداف الفلسطينية المرحلية الأساسية المعروفة -على الأقل- والتي كانت معتمدة بإجماع فصائل الثورة قبل (اتفاق أوسلو) دون تنازلات مبدئية وبلا قيد أو شرط، كمحطة مؤقتة على طريق الحل الإستراتيجي اللاحق.
– وبعبارة موجزة، إن لموازين القوى، أبعاداً كثيرة – كما ذكرنا- قد لا تتوفر كلها طبعاً للشعوب (المستضعفة)، ولكن البعد الأساسي الذي يجب توفره دوماً هو الإرادة السياسية والتصميم الثوري على الحرية والاستقلال، بوجود أنظمة ديمقراطية معبرة عن الجماهير.
وأذكر في مجال ضرورة وحيوية إشراك الجماهير والارتباط الكامل بأرض الوطن المقدسة، أسطورة قديمة عن مصارع مشهور لم يستطع أن يغلبه اي مصارع في عصره.. حتى جاء أحدهم فدرس وضعه، وتوصل إلى معرفة سر قوته وتفوقه على الجميع، وهو حرص المصارع المذكور على استمرار الالتصاق بالأرض، بشكل أو بآخر، حيث يستمد القوة من (أمه الأرض) .. فنازله وعمل على رفعه عن الأرض، وفصله عن مصدر قوته، فتمكن من التغلب عليه.
وهكذا فإن القوى والأنظمة الثورية التي تنبثق من الجماهير وتنصهر معها، وتظل منغرسة في أرض الوطن المقدسة، لا يمكن أن تغلب.
– ونذكر بهذه المناسبة أيضاً أن بعض الثوريين، وعلى رأسهم الشهيد الرمز تشي غيفارا كانوا يطرحون، سابقاً، ضرورة قيام عدة “فيتنامات” في وجه الإمبريالية، بحيث تستنزف قواها وتخور، كما يحدث للفيل الذي يمكن أن يتهاوى تدريجياً ويسقط إذا تعرض لعدة جروح ولو بأسلحة بسيطة، بفعل استمرار نزيف وتعفن تلك الجروح.
ومهما تبدو مثل هذه الأطروحات خيالية، وغير واقعية، في الظروف العالمية الجديدة، وهي كذلك فعلاً- وقد تبقى كذلك لزمن غير قصير- إلاّ أن توفرها لاحقاً بشكل أو بآخر، يشكل أحد الشروط الأساسية لتحرر شعوب العالم من العبودية الإمبريالية الحالية الشاملة.
– ففي مواجهة مقولة “موازين القوى” ثمة موقف إيجابي يتمثل في النضال لتغييرها لصالح الحق والقضايا العادلة، وموقف آخر يتخذها ذريعة للخضوع والاستسلام.
ومهما يكن، فلا يجوز التفريط بالقضية وإسقاط الحق بأي حال، بل مواصلة الضغط بهذا الحق بكل الوسائل المرنة والمتاحة، وصولاً إلى التغيير النوعي المحتم.
وثمة مثال كنت أردده في مواجهة المتسائلين عن الحل البديل للاستسلام؛ هو أنه لا يمكن للرجل الأعزل الذي يرافق أمه أو أخته أو ابنته أو زوجته، فتعترضه زمرة من الأشرار المسلحين.. أن يسلمهم عرضه وشرفه طوعاً واختياراً، ويجلس متفرجاً على انتهاكه متذرعاً بحجة “ميزان القوى” ، بل يقاومهم ويحاول ردعهم بكل طاقاته، حتى لو تعرض للاستشهاد (لأن الذي يموت دون عرضه وأرضه، فهو شهيد – حسب الحديث النبوي الشريف).. فربما يسمعه أحد الناس، أو المارة في هذه الحالة، فيتحمس لوضعه ويهب لنجدته وإنقاذه وآله، أو ينتقمون له من العصابة المعتدية حتى بعد استشهاده.
فكيف يكون الحال إزاء اغتصاب أرض الوطن المقدسة، العرض الأكبر والشرف القومي الأعم؟
• وإذا عدنا بمعادلة “ميزان القوى” من المستوى النظري العام والمواجهة المصيرية مع العدو الصهيوني الإمبريالي على الخصوص، التي هي مركز اهتمام كل المناضلين العرب، إلى المجالات الداخلية بين الأنظمة القائمة الطاغية المستبدة، وبين الجماهير وقواها الوطنية الديمقراطية المعارضة، حيث اصبح استمرار معظم هذه الأنظمة لأطول مدة عرفها التاريخ، حتى كاد يبلغ الاستمرار المتواصل لبعض حكامها حوالي نصف قرن!!! كانه قدر مسلط على صدر الشعب.. فإن تغيير هذه (المعادلة) لصالح الجماهير وإقامة أنظمة وطنية ديمقراطية بديلة قد أصبح يشكل نوعاً من الاستعصاء الذي يتجاوز تحليل آلياته المعقدة وكيفية وأساليب التغلب عليه، قدرة أي مناضل أو حزب بمفرده، ويحتاج إلى تضافر جهود كل المفكرين الثوريين والقوى الحية في الوطن العربي؛ لأن استمرار هذا الانسداد الخانق أصبح لا يطاق، فهو يستهلك الأجيال ويهدد مصير الوطن والأمة.
ولعل اجتهادنا في مواجهة هذه الحالة يشكل مجرد مساهمة بسيطة متواضعة في الجهد العلمي الثوري الجماعي المطلوب.
ومن المفارقات الفاجعة، أن مقاومة هذه الأنظمة (الأهلية) ،أي المكونة من الأهالي حتى لا نقول وطنية، أصبحت أشد صعوبة من مقاومة العدو الأجنبي، حيث يكون الفرز أكثر سهولة ووضوحاً بين الوطنيين والخونة. أما هنا، فالخلط قائم على قدم وساق، ولا حدود له، تحت مظلة الشعارات الوطنية والقومية و(الثورجية)، حيث تلجأ حشود الانتهازيين والمرتزقة، وتفرخ وتنمو التشكلات الطبقية البرجوازية الطفيلية الجديدة اللامنتمية، خاصة عبر سيطرة السلطة على كل وسائل الحياة في المجتمع، واستخدام المسجد ودور الحضانة، والمدرسة والجامعة والثكنة واجهزة الإعلام الحديثة، والمنظمات (النقابية) و(المهنية) (المفبركة)، في تعليب المجتمع المدني وتجميده وتهميشه، وتسطيح وعي الشعب وتضليله، وطمس وتشويه تاريخه وقلبه، بل استئصال ذاكرته وإضعاف وقتل حتى (غرائزه) ومناعته الطبيعية الوطنية والقومية، وإعادة (صنعه) على مقاسات النظام الديكتاتوري القائم، بحيث يتحول البلد إلى سجن كبير لا مكان فيه لأي عمل ديمقراطي مستقل: سياسياً أو اجتماعياً أو نقابياً أو ثقافياً من أي نوع كان، إلا ما يعزز ويصب في خدمة النظام وحدوده وأطره المرسومة.. فلا يسمع فيه صوت سوى صوته الذي يثير الغثيان، وأصدائه التي تصم الآذان، التي يرددها أتباعه في كل مكان حتى تحول المواطنون تحت وطأة هذا (القمع المركب) الجسدي، والسياسي والاقتصادي والاجتماعي و(الإيديولوجي) والثقافي والإعلامي.. إلخ، إلى نوع من القطعان البشرية تبحث عن وسائل العيش، فلا ترفع رؤوسها إلى الآفاق.. تشرف على (حراستها) أجهزة النظام و(كلابه) المتوحشة لتفترس من يحاول الخروج من (الزريبة) المخصصة (لقطيعه).
ثم ألا يجوز التساؤل عما إذا كانت هذه الأساليب المتداخلة الشاملة الفظيعة المزمنة، ربما تدفع الشعوب إلى (التعود) على الخضوع والاستكانة والاستقالة من العمل الوطني والركود والاستسلام لمثل هذا الواقع البالغ الفساد والتعايش معه كانه قدر لا يرد؟ بحيث تضعف استجابتها للأصوات المعارضة الحرة التي تدعو لرفضه ومقاومته والعمل على تغييره.. إلى دولة الحق والقانون الديمقراطية العادلة الكريمة؟ أي احتمال الوصول إلى ما يمكن تسميته بداء “فقدان المناعة السياسية” “الإيدز” عند الجماهير المقموعة.
وقديماً قال لينين ما معناه” “العادات لها قوة الغرائز”.. بل يمكن القول: أن الغرائز ذاتها هي حصيلة عادات متراكمة متفاعلة عبر عشرات آلاف السنين.
وهنا لابد من القول أن جميع الأنظمة العربية السابقة من رجعية وبرجوازية تقليدية، وتقدمية أيضاً، قد ساهمت، وإن بدرجات وأشكال متفاوتة، وبغض النظر عن النوايا، باغتصاب الديمقراطية في عملية ترويض الجماهير وإيصالها إلى حالة الخضوع الحالية المتردية التي لا نعتقد – رغم كل شيء، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بالشعب – أنها يمكن أن تدوم طويلاً، لأنه يتعذر على الإنسان استمرار العيش على جمر العبودية واشواك القهر والمذلة والتفقير والاستلاب والبؤس.
ورغم أن هذه الأنظمة الحالية تعتبر ساقطة بكل المفاهيم السياسية الحضارية المعروفة، كونها اثبتت عجزها الكامل عن حل مشاكل المواطنين الحياتية الداخلية المتفاقمة، ناهيكم عن حل القضايا الوطنية والقومية الملحة، وفي مقدمتها مواجهة العدو الصهيوني المحتل.. إذ لا تمتلك أي برنامج سياسي وطني ديمقراطي لتحقيق ذلك. وأصبحت بعد أكثر من ثلث قرن من التفرد المطلق بالسلطة تجسيداً للفشل في مواجهة هذه المهام المذكورة، بل العامل الأساسي في ترجيح ميزان القوى لصالح العدو، كما أصبح وجودها واستمرارها بالذات الحاجز الأكبر أمام أي جهد وطني وقومي مخلص لإنجاز هذه المهام، والمحافظة على قضايا الأمة وإنقاذ الأمة نفسها من مخاطر الضياع.
نقول، رغم أنها ساقطة بالمفهوم السياسي، فهي مع ذلك لا تزال مستمرة كابوساً خانقاً على صدر الوطن والشعب، لاتبدو له نهاية منظورة، وذلك بفعل عوامل عديدة نذكر منها:
=الدعم الخارجي المتعدد الأشكال.. وخاصة (البترودولار) بالنسبة للبعض، ودوره في تنمية الطبقة البرجوازية الطفيلية التي تشكل قاعدة هذه الأنظمة المعنية، والدعم الأجنبي المباشر بالنسبة للبعض الآخر، كون هذه الأنظمة اللاديمقراطية واللاوطنية التابعة أصبحت تتولى بدورها حماية المصالح الإمبريالية في المنطقة، وتنفيذ مخطط التسوية-التصفوية الأمريكي-الصهيوني المطروح، ومحاربة المشروع العربي الحضاري في عملية دعم متبادلة تضمن لها استمرار تسلطها على الجماهير والتحول إلى (وكيلة) للشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات في نهب إنتاج وجهود وثروات الوطن والشعب.
=القمع (المركب) الذي لم يسبق له مثيل، ويجمع بين همجية قرون الاستبداد الأشد وحشية وظلاماً،وآخر (مبتكرات) وتقنيات وآليات القمع والتعذيب (الحديثة) التي أنتجتها مخابر الإمبريالية والصهيونية لسجن الجماهير وقواها الطليعية.
=استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية، بل وجود (إسرائيل) بالذات الذي أصبح من ضمانات و(مبررات) بقاء العديد من هذه الأنظمة حتى الآن.
=اضطهاد وتمزيق وضرب وتصفية وتدجين القوى السياسية المعارضة، وعجز هذه المعارضات العربية عامة، وعملياً، عن تقديم وبلورة البدائل الديمقراطية الملموسة حتى الآن.
=عدم وجود قاعدة قومية تقدمية كمرجعية عربية، لدعم القوى المعارضة بنزاهة وإخلاص، انطلاقاً من الإيمان بوحدة العملية الثورية في الوطن العربي، وتعمل على توضيح الحقائق للجماهير وإسماعها الصوت العربي الديمقراطي الحر؛ بل إن معظم – إن لم نقل جميع- الأنظمة العربية تلتقي، مع كل تنافرها وصراعتها المعروفة، على هدف واحد وحيد فقط، هو: ملاحقة المعارضات العربية بحجة مكافحة الإرهاب وعدم التفريق بين الإرهاب الحقيقي المرفوض، وبين النضال الديمقراطي السلمي المشروع.
افتقار الوطن العربي -عامة- لأحزاب ثورية مؤهلة، وكون أحزاب المعارضة الديمقراطية الحالية – ومنها حزبنا- لا تضم طاقات كفاحية نوعية كافية (حتى لا نقول إستشهادية)، كالحركات الإسلامية الجديدة خاصة التي تتوفر على قدرات قتالية هامة، ولكن لا يؤدي عمل وتضحيات معظمها – باستثناء المنظمات المجاهدة ضد العدو الصهيوني طبعاً- إلى أية نتائج إيجابية ضد الأنظمة المعنية ، وذلك لأسباب عديدة، ليس مجال شرحها هنا، في مقدمتها نوعية ممارساتها واساليبها البشعة الفظيعة المنفرة للجماهير، وكذلك لافتقارها إلى برنامج سياسي ديمقراطي واضح يستجيب لمطالب وتطلعات وأهداف هذه الجماهير، مما اصبح يدعو للتساؤل عن احتمالات اختراقها وتلغيمها من جهات أخرى معادية؟.. كون بعض تلك الممارسات لا تمت إلى الإسلام بأية صلة، الأمر الذي لا يجعل تضحيات عناصرها تضيع سدى فحسب، بل تساهم عملياً – بصورة غير مباشرة، بغض النظر عن النوايا- في خدمة وتبرير وجود واستمرار الأنظمة القائمة بالذات، ثم في حرف الصراع الطبقي، وتأخير وإجهاض الانتفاضات الشعبية الحقيقية المطلوبة.
=وبالنسبة للمعارضة الوطنية الديمقراطية السورية بالذات، فهي لا تتوفر على أي هامش ديمقراطي على الإطلاق، بحيث تتاح لها فرص التجذر بين الجماهير وحقن نفسها بدماء شابة جديدة، كما أنها لا تتمتع بخبرات سابقة غنية وكافية في مجالات العمل السري، ولا تمتلك –بالتالي- الوسائل والآليات المبتكرة الفعالة اللازمة لمواجهة الآليات القمعية الجديدة حتى الآن، بل لا تزال – غالباً- أسيرة أساليب عملها السابقة العقيمة والمفوّتة تماماً، مع الأسف الشديد.
=وأمام حالة الانسداد المطبق المزمنة، واستمرار هذه الأنظمة الاستبدادية التابعة التي تمارس ما يمكن تسميته بعمليات (الخصي السياسي) المتواصل و(تعقيم) الجماهير عن إنتاج قوى ثورية مؤهلة جديدة.. أصبح، يبدو معها، أن تغيير أي نظام في الوطن العربي غير متاح، بل ومستحيل، بالطرق والوسائل الديمقراطية السلمية المتبعة في الأنظمة الديمقراطية المعروفة في العالم بأسره.
أصبح المطلوب – أمام هذه الحالة- من القوى الوطنية الديمقراطية العربية المعارضة –وبإلحاح شديد- المبادرة إلى الخروج من دائرة (الوضعية الانتظارية) المفرغة العقيمة والتآكل الذاتي المدمر، والبحث العلمي الجدي عن منافذ وأساليب وآليات عمل جديدة مناسبة لمواجهة هذه الأوضاع الاستبدادية التي تستهلك أجيال وحياة الأمة، وأصبحت لا تطاق بأي حال… قبل أن تفاجأ بانتفاضات شعبية عفوية عنيفة قد لا تعرف كيف تتعامل معها وتؤطره، وتحولها إلى تيار منظم ومتواصل، فتتعرض للإجهاض والتبدد، أو بانقلابات عسكرية لتغيير خيول عربات السلط القائمة عندما تستهلك وتشيخ وينتهي دورها، ولم تعد صالحة لخدمة الأسياد الإمبرياليين.
وقد يكون من الأساليب، التي تطرح على الفكر السياسي، أسلوب “اللاعنف” أو “المقاومة السلبية.. السلمية” التي اشتهر بها “غاندي” إبّان مقاومة الاستعمار الإنجليزي في الهند (وطالما كنا نرفضها، وندينه عليها – في ذلك الحين- رافعين شعار الكفاح المسلح، في فترات الشباب والنهوض التحرري العالمي المتصاعد).. باستخدام “العصيان المدني” السلمي، على سبيل المثال، الذي قد تلجأ إليه الجماهير في الساحات الناضجة لذلك. فعندما تضرب الجماهير بكل قطاعاتها داخل وخارج أجهزة الدولة، ويقاطع الشعب أجهزة الدولة سلمياً، لا تستطيع السلطة الاستمرار، أو سحق الشعب جماعياً وجره إلى العمل بالقوة.. كل هذا وغيره، يدعو إلى المزيد من التفكير من سائر القوى الحية في هذه الأمة، مع الأخذ بالاعتبار الصعوبات الإضافية الناجمة عن الظروف العالمية السائدة التي لا تساعد على أي تغيير تقدمي في الوطن العربي بالذات.. كونه – كما تعلن الإدارات الأمريكية المتعاقبة- مركز مصالحها القومية والحيوية الإمبريالية المعروفة.
o وقد يكون مفيداً أن نشير هنا – في هذا المجال- إلى كيفية التعامل مع معادلة “ميزان القوى” في “تجربة حزبنا” التي نحن بصدد دراستها أساساً في المجالات الحزبية الداخلية بالذات، خاصة عندما كانت بعض الأطراف المتصارعة داخل الحزب ترفض الاحتكام إلى النظام الداخلي والمؤسسات المنتخبة الشرعية المختصة، والقبول بالحلول الديمقراطية النظامية المتخذة.. وتلجأ – بدلاً من ذلك- إلى اساليب المناورات والمؤامرات والتكتلات لتغيير ميزان القوى الداخلي بالقوة، وعدم التورع من استعداء القوى غير الحزبية، وحتى التحالف –أحياناً- مع بعض الجهات الخارجية المعادية للحزب – كما سنرى مفصلاً في حينه- نكتفي بالقول هنا، كأحد الدروس الهامة للمستقبل، إن التعامل الناجح مع معادلة “ميزان القوى” المتحرك إيجاباً وسلباً يحتاج إلى قيادة موحدة منسجمة ومؤهلة ومتقاربة الوعي، وموثوقة من الحزب والجماهير، تعرف كيف تغتنم الفرص السانحة المواتية لصالح الحزب، في الوقت المناسب، لأنها قد لا تتكرر لاحقاً.
وكذلك، ومع ضرورة اتباع الأساليب المرنة (المضبوطة) جيداً لمواجهة المناورات والمؤامرات والكتل (السرطانية)، يجب حساب موازين القوى والإمكانات المتاحة واقعياً، لو أحسن تنظيمها وحشدها واستخدامها بدقة، وصولاً إلى لحظة الحسم النهائي التي تتطلب –عندها- الشجاعة والحزم وعدم التردد.
وكمثال عملي ملموس، كان “ميزان القوى” راجحاً بقوة لصالح الحزب، بعد هزيمة حزيران /1967/ وكان بالإمكان تغيير قيادة الجيش، عندئذ، بصورة رفاقية ودية، بدون أي مشكل وبمنتهى السهولة، بمجرد قرار من قيادة الحزب فقط، بما يخدم المصلحة الوطنية أساساً، ويحافظ على الحزب وجميع مناضليه بمن فيهم قيادة الجيش.. وبقي الميزان هكذا خلال فترات لا بأس بها. ولما لم يستغل في حينه، أخذ يتغير تدريجياً، لأن أكثرية الرفاق الحزبيين الساحقة الذين كانوا يثقون بقيادة الحزب ويؤمنون بقوتها وتماسكها وسيطرتها المطلقة وقدرتها على الحسم والإمساك بزمام الأمور، أخذ تماسكهم يضعف إذ بدأ بعضهم من الذين يرصدون الأوضاع ويحسبون اتجاه الرياح، من البيروقراطيين المزدوجين والمنافقين المصلحيين والانتهازيين المذعورين من إستراتيجية الحزب الثورية، يشعرون بغير ذلك.. فأخذوا يبحثون عن مراكز لهم مع قيادة الجيش التي كانت تخطط لاستقطابهم وتشجيعهم.. التي لاحظوا أنها قد تكون الرابحة في نهاية المطاف. وهكذا كان، كما سيرد لاحقاً.
* وفي الختام نعود إلى مسألة “ميزان القوى” الراهن في صراعنا القومي المصيري مع العدو الصهيوني الإمبريالي لنؤكد مجدداً أنها مسألة مؤقتة ومرتبطة بسيطرة الجماهير العربية على مقدراتها الهائلة.
ولنا في مثل هذه الحالات عبرة في الكائنات الحية من نباتية وحيوانية، التي تلجأ إلى أشكال لا تعد ولا تحصى من أساليب الكمون والوقاية، للحفاظ على الحياة والنوع في مواجهة تقلبات الطبيعة القاسية؛ فالبذور المنطمرة في أعماق التربة مثلاً، سرعان ما تنبثق في الربيع لتجسد عرس الطبيعة، وتغمر الأرض – التي كانت تبدو جرداء- بالخضرة والجمال والعطاء.
كذلك حال الشعوب التي تواجه قوى أجنبية معتدية طاغية، فلها عبقريتها الخاصة أيضاً. ولا تتخلى عن قضاياها المبدئية وتسلم بحقوقها القومية العادلة أو تعقد الاتفاقات التنازلية مع العدو، في ظل ميزان القوى المناقض لهذه الحقوق، بل تبحث عن أساليب وأشكال المقاومة المناسبة وتلجا أحياناً للتحصن والاحتماء بمخزونها التاريخي الديني والقومي الحضاري، وتسعى لإفشال وعرقلة محاولات العدو ريثما يصل التراكم الكمي إلى الثورة التحررية الناجحة.
ولا نكل ولا نمل –في هذا المجال- من التذكير بمثال التجربة الجزائرية المتميزة العظيمة التي واجهت الاستعمار الفرنسي طيلة أكثر من 130 سنة، بموازين قوى طاغية لصالح العدو، ولكن لم يُسلِّم أي من قادة تلك الثورات المتتالية (الفاشلة).. بأطروحة “الجزائر الفرنسية” بأي حال، حيث تفجرت ثورة نوفمبر 1954 التحررية الظافرة.
مع التذكير أيضاً، بأن القوى والإمكانات والطاقات العربية المتوفرة حالياً والكامنة أكبر بما لا يقاس من طاقات العدو الصهيوني. والمهم أن تناضل جميع القوى العربية الحية للسيطرة على هذه القوى والإمكانات والطاقات،ووضعها في خدمة الوطن والقضية لتحقيق النصر الأكيد.
هوامش:
* ملاحظة هامة جداً: كتبت هذه الصفحات –قبل الانتصار “الإستراتيجي التاريخي” التي حققته “المقاومة الإسلامية” بقيادة “حزب الله” في لبنان ضد العدو الصهيوني-الإمبريالي في شهر (تموز 2006) الذي أكد صحة هذه الإستراتيجية…وضرورة تعميمها في كل الساحات العربية المعنية…
** ملاحظة: كتب هذا النص قبل احتلال العراق الشقيق وبروز المقاومة الوطنية الإسلامية الجبارة –التي ستكنسه هو وعملاؤه في وقت غير بعيد.
 البعث الديمقراطي
البعث الديمقراطي